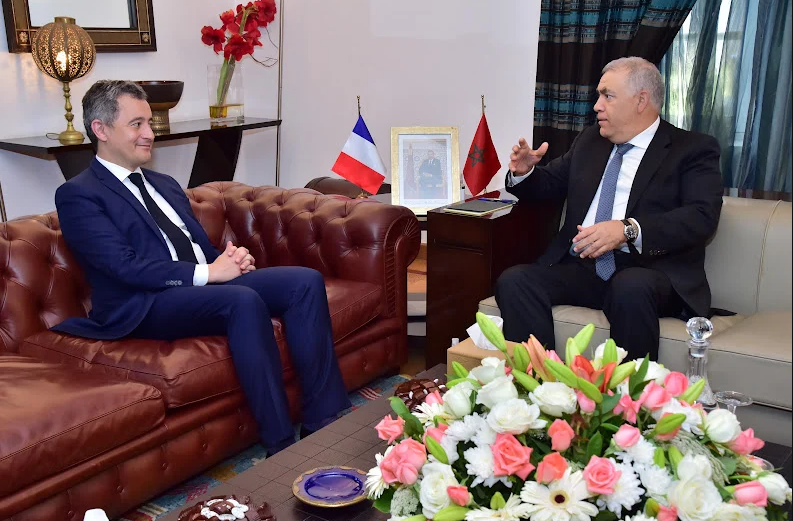العابثون بالأموال.. أجدادنا الذين اقتنوا الغليون و السيجار

«من الناحية العملية لا يوجد شيء اسمه إدارة، هناك جهاز لجمع المال فقط وليس هناك من يتقاضى أجرا سوى وزير الخارجية في طنجة وموظفي الجمارك، أما بقية الموظفين فهم على اختلاف درجاتهم يعتمدون على ما تعطيه لهم وظائفهم من نفوذ لجمع الهدايا والرشاوى فقط..»، هذه فقط بداية تقرير مثير يسمى تقرير ريدجواي عن واقع الأثرياء المغاربة، الذين كانوا مستعدين للقيام بأي شيء، إلا أداء الضريبة للدولة.
عندما بدأ الخناق يشتد على المغرب في واحدة من أحلك المحطات الاقتصادية، كان بعض الأثرياء، خصوصا في ميناء الصويرة، حيث كان أبرزهم من اليهود، يفكرون جديا في الهجرة نهائيا من المغرب، وبالضبط إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت وقتها في طور البناء. كانت الأخبار القادمة إليهم تؤكد أن هناك إقلاعا اقتصاديا في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن القيام برحلات سنوية إلى أمريكا عبر السفن المحملة بالسلع، من شأنه أن يضاعف ثرواتهم بشكل لا يصدق.
المشكل أن عددا من هؤلاء التجار كانوا يدينون لخزينة الدولة بأموال طائلة، ولم يفلح أعتى موظفو الميناء صلابة في إجبارهم على أدائها، وجدير بالذكر أيضا أن الدولة تساهلت مع أغلبهم في فترات متفرقة وأعفتهم من الديون مقابل أن يبدؤوا صفحة جديدة مع جباة الضرائب، لكن شيئا من ذلك لم يقع.
كان جد فيكتور المالح، الملياردير الأمريكي الذي ولد في الصويرة وهاجر منها طفلا، والذي توفي قبل سنتين في «نيويورك» واستأثر خبر وفاته باهتمام الصحافة الأمريكية، قد هاجر إلى أمريكا في السياق نفسه. فبعد أن كانت تجارته مزدهرة في الصويرة، قرر أن يغامر ويستقر نهائيا في أمريكا بعد أن وصلته أخبار بأنها دولة في طور البناء، وأنها تشهد يوميا وصول عدد هائل من المهاجرين لاستوطانها. رحل الجد وأسس حياة جديدة هناك، والتحقت به العائلة ومعها فيكتور المالح، الذي سيصبح من أشهر رجال الأعمال في العالم.
لكن ما يهمنا هنا، هو السياق الأول لرحيل جيل جد فيكتور المالح. فقد ورد في بعض المصادر التاريخية التي سنأتي إليها بالتفصيل في هذا الملف، أن بعض اليهود المغاربة هاجروا نهائيا، فيما قرر بعضهم الذهاب في رحلات استكشافية فقط، والعودة إلى الصويرة التي كانت معقل كل أنشطتهم التجارية في مجال الاستيراد والتصدير.
أحد التجار اليهود، كان موضوع بحث من طرف المخزن وصدرت رسائل رسمية من القصر الملكي مباشرة تطالب بتوقيفه في الميناء، لأنه كان قد تمادى في التهرب من أداء الضرائب لخزينة الدولة.. ففكر في الهروب إلى أمريكا على غرار عائلة المالح وأسر أخرى هاجرت نهائيا، لكن أصدقاءه نصحوه بالبحث عن حل للمشكل، خصوصا وأن تجارته في الخارج قد تتعرض للانهيار في أية لحظة، ما دام المشكل الجمركي لم يحل. الطريف في القصة كلها، أن هذا التاجر اليهودي قد فكر جديا في مفاتحة بعض أصدقائه الأوربيين الذين كانوا ينشطون في تجارة السلع القادمة من الهند، ويقترح عليهم إمكانية شراء الجمارك في الميناء، حتى يحولوها إلى شركة خاصة وينقذ نفسه من التهرب من أداء الضرائب، ويهاجر إلى أمريكا لإحضار سلع جديدة من هناك وغمر السوق المغربي بها.
المثير أن القصة وصلت إلى القصر، وقابلها بعض المستشارين بكثير من الجدية، وصار بعضهم يفكر في بحث سعر مناسب لاقتراحه على القصر مقابل بيع ميناء الصويرة، قبل أن يتدخل بعض التجار النافذين لينبهوا السلطان إلى خطورة ما يحاك في الخفاء، ليتم إلغاء كل شيء، خصوصا وأن تدبير الميناء لم يكن من الأمور التي يمكن أن تفوض للأجانب.
التاريخ المنسي للضريبة على وسائل الترف
إذا كان موظفو الدولة يرغبون خلال سنة 1905 بالحصول على ساعات ذهبية، من تلك التي يحملها الفرنسيون في جيوبهم وينظرون إليها بين الفينة والأخرى لمعرفة التوقيت، فإنه كان يتعين عليهم طلبها بشكل قانوني رسمي، وأداء ضريبة عنها للدولة. لكنهم، أي الموظفين، كانوا يهمسون سرا في آذان الأجانب، ليطلبوا منهم إحضار ساعات ذهبية معهم، وإدخالها مخبأة بين ملابسهم إلى المغرب، ملتفين بذلك حول قانون الضرائب على وسائل الترف.
هذا القانون، كان مصدره أحد زوار المغرب.. نعم، شخص كان في زيارة إلى المغرب، فتعرف على بعض العاملين في السلك الدبلوماسي، ووعدوه بأن يقدموه إلى القصر ليحضر معهم أحد الاحتفالات، وكان في الأصل تاجر أسلحة، جاب بلدانا كثيرة. استغل الفرصة للتقرب من السلطان، بعد أن كذب على الوزراء وأخبرهم أنه كان يدير مشروعا كبيرا في لندن، وأنه تخلى عن كل شيء هناك محاولا توسيع تجارته. لكن الحقيقة أنه كان باحثا عن الفرص متصيدا الكنوز. أغدق القصر عليه الهدايا، وأصبح يتردد بين الفينة والأخرى على البوابة للقاء السلطان عبد العزيز، ابن المولى الحسن الأول.. في إحدى المرات اشتكى له المولى عبد العزيز من قلة موارد الدولة، فاقترح عليه أن يسن نظام ضرائب شبيه بنظام بريطانيا، وهكذا سيكون على كل المغاربة أن يقدموا الضرائب للدولة باستمرار عن كل ما يملكونه.
تم اعتماد خطة الضرائب الجديدة، فتركت انطباعا سيئا لدى الناس، خصوصا وأن المغرب وقتها كان يعيش على إيقاع مجاعة كبيرة. لم يتقبل المغاربة الفقراء أن يؤدوا ضرائب عن كل رأس غنم يبيعونه في السوق، أو كومة من الحبوب، حتى أن الضرائب شملت الدواجن.. كادت أن تقوم ثورة ضد المخزن من جديد في فترة انتقالية حساسة، لم تكن الدولة خلالها تتوفر على جنود لفرض النظام. همس مقربو المولى عبد العزيز في أذنه، بأن صديقه البريطاني هو سبب البلوى، فقام القايد ماكلين، الأسكتلندي الذي أصبح مغربيا، بتحذير البريطاني من غضب قادم في الطريق، ونصحه بأن يكف عن اقتراح حلول لمشاكل المغرب، ففهم الأخير الرسالة وفر في أول سفينة خارجة من الميناء، حتى ينجو بحياته.. حتى أن بعض أصدقاء القايد ماكلين أخبروه أن البريطاني، الذي اختلفت بعض المصادر حول اسمه، وتناقضت بهذا الخصوص، كان رأسه مطلوبا لدى بعض حاشية القصر، لأنهم كانوا متحفظين حول وقاحته في اقتحام القصر في أي وقت يشاء، ووجدوا في فشل نصيحته الاقتصادية فرصة لإنهاء وجوده، ليس داخل القصر فقط، وإنما على قيد الحياة أيضا.
الضريبة إذن كانت فاشلة، وأهم سبب لرفضها من طرف الناس، هو أنهم لم يتقبلوا أن يؤدوا الضرائب عن خبزهم وماشيتهم، فيما الأغنياء كانوا منزهين عن أداء ضرائب للدولة عن وسائل الترف التي كانوا يحصلون عليها من الخارج، وأولها الشاي والأثواب النادرة والتبغ والمجوهرات، خصوصا المقتنيات القادمة من الصين والهند، عبر بريطانيا.
وفي مرحلة لاحقة، كانت المقتنيات الأوربية كالدراجات والسيارات، تشهد رواجا كبيرا في المغرب، لكن المؤسف أن كل الذين كانوا يطلبونها، كانوا متأكدين أنهم لن يدفعوا فلسا واحدا لخزينة الدولة، مقابل حصولهم على هذا النوع من البضائع.
انتبه الأوربيون إلى هذا الأمر، لكنهم لم يخاطروا باقتراح فرض ضرائب عليه، مخافة أن يتراجع الطلب المغربي على وسائل الترف. وسيزول الضباب إذا علمنا أن موانئ الدول الأجنبية كانت تفرض على المغاربة رسوم تنقيل تلك المقتنيات إلى المغرب، وهو ما كان يعتبر بمثابة ضريبة غير مباشرة، وكان المغاربة يدفعونها عن طيب خاطر، معتبرين أنها تدخل في الثمن الإجمالي لتلك المقتنيات. أما في المغرب فقد كانوا يتهربون من أداء ما في ذمتهم للدولة. المعركة بدأت سنة 1856، عندما فكر المغرب في عقد اتفاقية مع أوربا، بخصوص المبادلات التجارية عبر الموانئ، وحاولت الدولة فرض ضرائب على المغاربة الأثرياء، لكنها فشلت في استخلاص ما في ذمتهم، ليصبح الأمر قصة مثيرة عن علاقة المال بالنفوذ..
لهذه الأسباب قرر أغنياء المغرب التمرد على نظام الضريبة
لم يكن أحد من الأعيان المغاربة مهتما بمصير الاتفاقيات التي كان يعقدها المغرب مع الأوربيين، خصوصا خلال سنة 1856، فقد كان بعضهم يجتمعون سرا في إحدى الإقامات الفاخرة في فاس ومراكش، للتآمر ضد نظام الضرائب والأعشار، فقد كانوا يرون أن «المخزن» يبحث فقط عن طرق جديدة لإعادة ملء الخزينة.
لكن الحقيقة، حسب بعض المراجع التاريخية الرسمية، أن الدولة كانت وقتها بصدد التأسيس لعلاقات تجارية خارجية، أملتها الظروف المحيطة بالمغرب، ما دام قد تلقى عروضا بهذا الخصوص ولم يكن مبادرا إليها، فاجتمع مستشارو القصر في فاس، والتي كانت وقتها عاصمة للمغرب، وقرروا أن يسن السلطان سياسة ضريبية جديدة، وحذروه من بعض التجار الذين ولا شك ستتضاعف أرباحهم في حال ما إذا سمحت الدولة المغربية للسلع الأجنبية بالنزول في موانئ طنجة، الناظور، الصويرة.
في هذه الموانئ، كانت عيون الدولة مفتوحة على كل شيء، قبل 1856، وكان كل التجار الذين يصدّرون السلع والمنتوجات المحلية ويستقبلون مكانها سلعا أوربية ومواد صناعية معروفين، وكل تحركاتهم مسجلة في دفتر الجمارك.
وعلى ذكر هذا الدفتر، فقد كتب أحد الأعيان الإنجليز، أنه لبّى عزيمة من أحد التجار اليهود في مدينة الصويرة، واسمه «حاييم»، أو هكذا أسماه في صفحتين تحدث فيهما عما دار بينهما خلال ذلك العشاء. وللأمانة، فإننا هنا لم نعتمد ترجمة حرفية، لأن صاحب الكتاب توغل في تفاصيل كثيرة لا تخدم موضوعنا في شيء. جاء في شهادته، أو بعض منها إذن، ما يلي: «لم أكن أعلم أن السيد حاييم نافذ جدا. تعرفت عليه في ميناء الصويرة عن طريق السيد دوركاييم ودعانا إلى العشاء. دوركاييم تخلف عن الحضور لأن وعكة صحية ألمت به وأصيب بإسهال حاد. أشك أنه تناول شيئا فاسدا. لبيت الدعوة وحيدا في ذلك المساء، ووجدت ضيوفا آخرين سبقوني للحضور. فهمت من خلال كلام حاييم أنهم جميعا يهود، وأن من بينهم من يحتفظ بعلاقات نافذة جدا مع موظفي الدولة ومسؤولي الضرائب. عندما انتهى العشاء أخرج أحدهم أوراقا كثيرة من ثوبه ومدها لحاييم. نظرت إليه في حيرة لأن الفضول تملكني لمعرفة محتويات الأوراق الكثيرة التي يحملها، لكنه لم يخبرن بأي شيء. لكن في اليوم الموالي، وبينما كنت بصدد البحث في الميناء عن سفينة تهم بالمغادرة في أقرب الآجال، التقيت حاييم يتجول بين البضائع، وقبل أن أستفسره عن لغز أوراق سهرة الأمس، أخبرني أن أحد المدعوين لم يكن يريد أن يكشف لي الأمر، لأن الأوراق كانت سرية، وتسلمها من أحد أصدقائه العاملين في الميناء ليلقي عليها حاييم نظرة سريعة قبل إعادتها، لأنها مسروقة من السجل الكبير الذي يدون فيه كل شيء. أخبرني أن البعض يكتفون بإلقاء نظرة على أرقام خصومهم في التجارة، بينما آخرون يدفعون رشاوى مهمة لمحو بعض الأرقام، أو تخفيض عدد السلع المصرح بها، حتى لا يفاجئهم المخازنية يوما بأداء الضرائب».
بالعودة إلى الاتفاقية التجارية البحرية لسنة 1856، فإنها كانت تركز بالأساس على حماية النظام الضريبي المغربي، وهذا ما لم يستسغه التجار والأٌثرياء المغاربة، خصوصا وأننا رأينا كيف كانوا يتصرفون قبل مجيء الاتفاقية، ولهذا السبب بالضبط كان أغلبهم يرى فيها تهديدا لمستقبل ثروتهم، رغم أن الدولة وقتها كانت ترى فيها انفتاحا تجاريا، من شأنه أن ينقذ خزينة الدولة من العجز الكبير الذي كانت تعانيه.
لوبي قوي واجه بنود اتفاقية 1856.. المتاجرة في كل شيء إلا التبغ والرصاص
لم تكن هي القشة التي قصمت ظهر البعير، فبحسب بعض المراجع التاريخية الرسمية، التي أشارت إليها اعتمادا على أرشيف القصر الملكي، الذي كان المؤرخ عبد الرحمن بن زيدان أحد أبرز المطلعين عليه، فإن الاتفاقية التجارية التي أشرف المغرب في صياغة بنودها سنة 1856، كان لها وقع كبير على الاقتصاد المغربي وعلى خزينة الدولة. فبالرغم من أن التجار المغاربة لم يستقبلوها ولو بقليل من الحفاوة، إلا أنها بحسب بعض المراجع، أنقذت المغرب من سكتة اقتصادية.
لم يكن مرعبا أن تصاب البلاد بالسكتة القلبية في الاقتصاد، لأن الحقيقة أن المغاربة كانوا قد اعتادوا على الأمر قبل ذلك التاريخ، وتوالت عليهم المناسبات التي كانت فيها خزينة الدولة خالية تماما من المال. الذين كانوا يتخوفون من الأزمات هم الأعيان، بالرغم من أن بعضهم كانوا يجعلون تجارتهم ومواردها بعيدة عن متناول عامة الشعب، وينشغلون عن الجميع بتوطيد العلاقات مع الأجانب.
هنا مربط الفرس.. فقد جاء في البند الثالث من الاتفاقية التي تتوفر «الأخبار» على النص الكامل لها، أن سلطان مراكش قد وافق سنة 1856 بالتعهد بإسقاط «الكنطردات، والممنوعات في المتاجر، إلا التبغ والأفيون والكبريت والبارود وملحته، وأيضا الرصاص وآلات الحرب والأسلحة»، بالإضافة إلى ما أسمته الاتفاقية «الربيع الذي يشرب في الدواية»، ويقصد بها وقتها، الخليط الذي يُحرق في الغليون، إذ لم يكن وقتها تدخين التبغ بواسطة الغليون متداولا في المغرب.
بالنسبة إلى التجار المغاربة، فإنهم كانوا غير معنيين بالسماح أو منع ترويج هذه السلع التي ذكرناها قبل قليل. فما كان يهم التجار المغاربة، خصوصا منهم الذين كوّنوا ثروتهم عبر الاتجار في المواد الغذائية والاستهلاكية، هو تضمن الاتفاقية لكل ما من شأنه أن يضر بمصالحهم.
كان التجار المغاربة والأغنياء يشكلون «لوبيا» حقيقيا لمواجهة سياسات الدولة، وهو أمر أشار إليه مؤرخ يدعى وليام روجرز، إذ قال إن الأوربيين واجهوا مشاكل حقيقية على أرض الواقع، رغم التزامهم بالاتفاقيات التجارية مع المغرب، والسبب حسب وليام، هو أن التجار المغاربة كانوا يتبرمون دائما ويبحثون عن سبل لعقد مبادلاتهم التجارية، بعيدا عن أعين جباة الضرائب. ومن هنا استمد اللوبي المغربي قوته، خصوصا وأن الإدارة المغربية كانت ضعيفة تماما، ولم تكن لها مؤهلات لتتبع مسار عقود البيع والشراء، ولا حتى استخلاص الضرائب.
استخلاص الضرائب كان معضلة كبيرة لوحده، فقد راج أن بعض التجار المغاربة كانوا فوق القانون، ليس فقط في المدن التي تشهد تركزا للسلطة كفاس ومراكش والرباط، ولكن أيضا في جميع المناطق التي تشهد رواجا اقتصاديا بحكم موقعها الجغرافي، أو رصيدها التاريخي.. في كل مدينة كان هناك أشخاص لا يمكن أبدا إجبارهم على أداء الضرائب للدولة، حتى لو جاء موظفو المخزن برسائل رسمية لتعجيل التنفيذ. وقد كانت تجربة جباة الضرائب مع هذا النوع من التجار كبيرة، إلى درجة أن أحد موظفي المخزن النافذين كان قد توعد أحد أثرياء مراكش بمصادرة ثروته، لأنه تمادى في تأخير تسديد ما عليه من ضرائب لخزينة الدولة، وكان قد صدر أمر من القصر الملكي وقتها أن يتم توفير مبلغ معين لتغطية مصاريف رجال الجيش، لإخماد أحد التمردات. لكن القصة انتهت بشكل غير متوقع، لأن موظف المخزن الذي كان مشرفا على استخلاص هذا النوع من الضرائب، حصل على هدية سخية من أحد التجار لكي يجبر التاجر الأول على أداء ما في ذمته، فما كان من الأخير إلا أن سلح بعض خدامه، وأمرهم بدعم التمرد القائم في الأطلس، لتصبح المصيبة مصيبتين، ويتم طي الموضوع في الأخير، خصوصا وأن احتواء التمرد وعقد المصالحة كان هو النتيجة التي جنحت لها الأطراف في الأخير. لكن الخطير في الأمر، أن التاجر لم يؤد ما عليه من ضرائب، وتقول بعض المراجع إن هناك قصصا كثيرة لتجار مغاربة لم يقوموا أبدا بأداء ما في ذمتهم من ضرائب للدولة، واكتفوا بتقديم الهدايا والعطايا في المناسبات لموظفي المخزن، والرشاوى بطبيعة الحال.
حكاية تقرير ريدجواي.. الموظف الوحيد الذي يحصل على أجرته في المغرب هو وزير الخارجية
لم يكن عدم الاستقرار السياسي ليخدم الأهداف التجارية. فبينما كانت بريطانيا تخطط لبدء عهد تجاري مع المغرب، لتصريف فائض سلعها، خصوصا وأن فترة طويلة قد مرت على اتفاقية 1856، كان أحد مواطنيها المقيمين في طنجة قد تعرض للقتل. حسب المؤرخ البريطاني وليام روجرز، فإنه المدعو جوان ترينداد في دجنبر من العام 1892، وصدرت تعليمات لطلب تعويض من المغرب قدره خمسة آلاف ريال، وهو مبلغ كبير وقتها. جاء في إفادة وليام روجرز أن «جاءت تعليمات لإليوت بطلب تعويض قدره 5 آلاف ريال، بالإضافة إلى إنزال العقوبة بالحراس، ولوم الحاج محمد طوريس، نائب السلطان في الشؤون الخارجية، والذي ادعى أنه شمل الحراس بحمايته..». يستمر المؤرخ في سرد تفاصيل الواقعة وعلاقتها بتوتر العلاقات، إلى درجة صدور قرار تعيين بعثة ريدجواي إلى المغرب، فقد كانت مهمة الأخير هي إعادة علاقة الصداقة القديمة التي استمرت قائمة لمدة طويلة بين بريطانيا والمغرب.
ريدجواي هذا، وبعد انتهاء مهمته في المغرب، والتي استمرت لأسابيع فقط، كتب تقريرا مفصلا للقصر البريطاني، جاء في إحدى فقراته إشارة مهمة: «ثم إن فرنسا لا تثير الحساسيات الشريفة مثل إنجلترا، وهي لا تلقي المواعظ على السلطان، ولا تقرأ له المحاضرات عن مساوئ الإدارة، ولا تطلب منه الامتيازات التجارية الكبيرة، بل تقبل بشكر ما هو راغب في إعطائه وحسب.. ويقينا فقد وجدت لدى وصولي إلى طنجة، أن نفوذ كافة الدول بما فيها بريطانيا قد انتهى من الناحية الفعلية، في ما عدا النفوذ الفرنسي..».
ولكنه عندما تحدث عن الضرائب المغربية والجمارك قال ما يلي، بحسب المؤرخ وليام روجرز: «من الناحية العملية لا يوجد شيء اسمه إدارة، هناك جهاز لجمع المال فقط، وليس هناك من يتقاضى أجرا سوى وزير الخارجية في طنجة وموظفي الجمارك، أما بقية الموظفين فهم على اختلاف درجاتهم يعتمدون على ما تعطيه لهم وظائفهم من نفوذ لجمع الهدايا والرشاوى فقط.. أما عن السلطان فهو متدين ومثابر ومقتصد، كما أنه على جلال وكرم مظهر ويشرف على كل التفاصيل، ولا يستطيع أي وزير إرسال أي خطاب دون أن يراه أو يمر عليه..».
من هنا جاءت «السيبة».. حكاية قرنين من الرشاوى
قد لا يكون كلام ريدجواي صحيحا في جملته، لكنه يحمل جانبا من الواقع في تفاصيله، وهذا الكلام يطابق، على الأقل، ما جاء في تاريخنا الجماعي. لم يكن المغرب منضبطا من الناحية الإدارية، ونحن بدورنا لا نحتاج إلى مراجع أجنبية أو وثائق سرية من أرشيف وزارة الخارجية لدولة أخرى، لكي نقف عند هذه الخلاصة.
جاء في مراجع أجنبية ومحلية أيضا، أن الإدارة المغربية بشكلها التقليدي ووزراءها الذين كانوا عتيقي التفكير والطراز أيضا، لم تكن توفر حماية للدولة من نفوذ موظفيها، والنتيجة كانت أن نحصل على موظفين في قطاعات حيوية، اشتغلوا لصالح أنفسهم واتخذوا الدولة مطية، لا أقل ولا أكثر.
هنا نفرد واقعة طريفة لأحد أفراد البعثة الإيطالية إلى المغرب، خلال بدايات القرن 19. هذه الشهادة قد لا تكون دقيقة في مضمونها لأنها، وحسب المراجع التي وفرتها، نُقلت عن اللغة الإيطالية إلى الفرنسية، بعدما عثر عليها أحد أفراد بعثة فرنسية طبية إلى المغرب، ثم جاء الدور على أحد موظفي السلك الدبلوماسي، ليطالعها بالفرنسية ويقرر ترجمتها إلى الإنجليزية، وتنشر لاحقا في الصحافة البريطانية، خلال الفترة التي كانت فيها صحف لندن تبحث عن مواضيع بخصوص المغرب، لأن الرأي العام البريطاني كان مهتما بمعرفة حقيقة المغرب ولغز الأهمية التي توليها بريطانيا لضم المغرب إلى مستعمراتها. جاء في الشهادة ما يلي: «ثلاثة منا لم يكونوا قادرين على مواصلة الطريق بالخيول، فقرر رئيس الوفد أن يعودوا إلى طنجة وينزلوا في فندق هناك وألا يغادروه إلا بعد عودتنا من فاس. عندما وصلنا إليها، بعد رحلة شاقة وعسيرة، رغم أن السلطات اجتهدت في توفير الخيول والعربات لنقلنا في أحسن الظروف، بقينا ننتظر لساعات دون أن يستقبلنا أحد. كان الجميع ينظرون إلينا بتجهم ويبتعدون عنا، ولم يحاول أحد التقرب منا أو استفسارنا، رغم أن الذين رافقونا في الطريق أخبروهم أننا هنا للقاء السلطان ووزرائه لتقديم رسالة مهمة من إيطاليا. كان كل من يسمع هذا الكلام يشيح عنا بوجهه ويمضي إلى الداخل، وبقينا على تلك الحال ننتظر أمام البوابة الخشبية الكبيرة، حيث الخيول والروث والحرارة المرتفعة.
من حسن حظنا أن الباب فتح قبل وقت الغداء بقليل لتخرج بعض العربات، فلمحنا أحد رجال السلطان وأوقف العربة ونزل ليتحدث إلى مرافقينا وكان عددهم 5 رجال. ما إن سمع منهم الحكاية، حتى وضع يده على رأسه وشرع في الصراخ في كل من حوله، وأمرهم أن يفتحوا البوابة حالا. ظننا أن مشكلتنا انتهت، لكننا واجهنا مشكلا آخر عندما أردنا الدخول إلى القصر، فقد أخبرنا المرافقون أن بعض المشرفين على مواعد استقبال السلطان لضيوفه، يشترطون الحصول على هدايا مقابل تسريع وتيرة تحديد الموعد، ووجدنا أنفسنا مجبرين على إكرامهم ببعض المال، لتفتح لنا الأبواب ويستقبلنا المشرفون على تنظيم لقائنا بالسلطان لتبليغ الرسالة، ومحاولة فتح باب لحثه على الموافقة».
المثير في هذه القصة، أن الإيطاليين بدورهم، وبعد مضي سنوات طويلة على اتفاقية 1856 التي لم تكن إيطاليا معنية بها بطبيعة الحال، كانوا شاهدين على ما مرت به العلاقات المغربية البريطانية بقليل من الاختلافات. فالمغرب وقت بداية توطيده للعلاقات مع البريطانيين كان حريصا على استقبالهم، وفي وقت مجيء الإيطاليين كان المغرب شديد الاحتراس في مصافحة الأيادي الأجنبية، خصوصا القادمة من وراء بحر أوربا.. والأهم من هذا كله، أن موظفي الدولة كانوا دائما يضربون دائرة محكمة حول مصالح الدولة، ولا تصل إليها الأطراف، إلا بعد المرور عليهم.
توالت قصص كثيرة لوقائع مشابهة اختلفت تفاصيلها، لكنها التقت في النتيجة والخلاصة أيضا. الخلاصة أن هناك تاريخا كبيرا من التسيب المالي الذي أضاع على المغرب فرصا كثيرة لحماية حدوده من التوغل الأجنبي، وهو ما أوقع البلاد في مشاكل كثيرة ومجاعات أيضا، والنتيجة كانت أن بعض الأعيان الذين تقووا في هذه الظروف، شكلوا قوة ضغط كبيرة عندما أصبحوا محميين، وجعلوا البلاد تفرض على نفسها، قوى للتحكم بمباركة الفرنسيين والبريطانيين، إذ لم يعودوا في حاجة إلى مفاوضة الدولة، ما دام هناك مغاربة قد أصبحوا رعايا دائمين لهم، وتسري عليهم قوانين الدول الأوربية، رغم أنهم في المغرب.
من 1856 إلى أن فرضت الحماية رسميا على المغرب، احتاج الغرب إلى كل هذه المدة ليتفهم الخصوصية المغربية، ويستخلص أن التحكم في دواليب سير الأمور في المغرب لن يتم إلا بالتحكم في الأعيان والتجار الذين كانوا يرفضون أداء الضرائب للدولة.